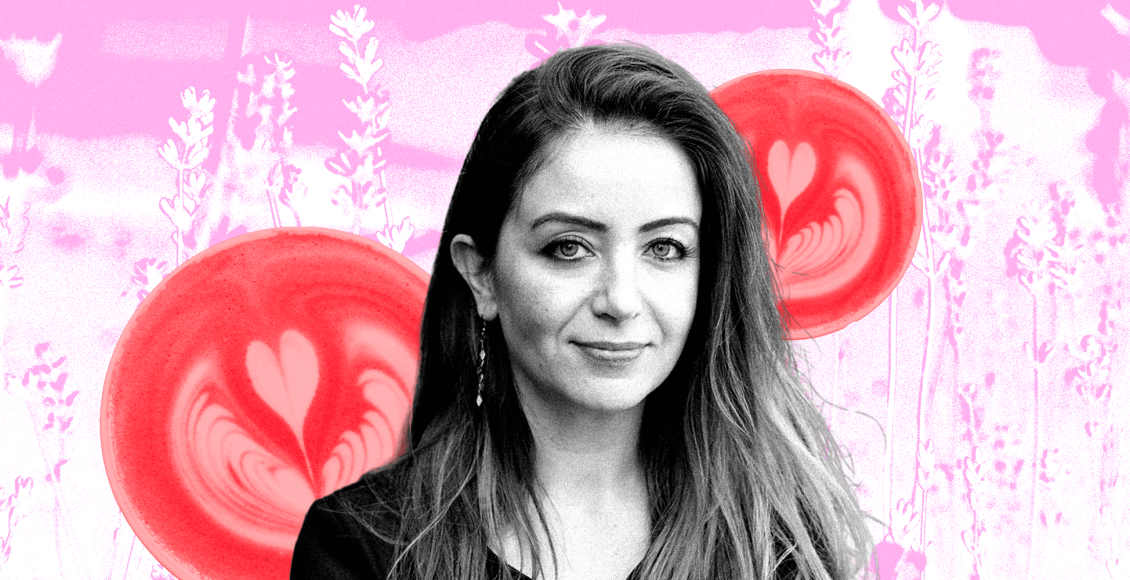كفتاة إدلبية تعلّمت باكراً أن تجنُّب النظر في عيون المارة والمشي بسرعة نحو وجهتك أداة فعّالة لتخفيف “الشلي” (أي النميمة) التي ستتعرضين لها، فطوّرت مهارات متقدّمة في المشي على الطريقة العسكرية “نظام منضّم” مع تخفيف كل ما يُمكن أن يلفت الانتباه الي، فالاختفاء في مدينتي الصغيرة ليس خياراً، وأقصى ما يُمكن للبنت أن تطمح له هو تخفيف عدد السيَر التي تتناولها.
لم أكن أية فتاة أيضاً، كنت غير محجبة عكس غالبية بنات جيلي، وكنت ابنة امرأة مطلقة من طبقة أقرب للفقيرة، وليس خلفي “رجال أقوياء” او بارزين أسند عليهم في الشدائد.
ولهذا توّجب علي تطوير أدوات دفاعية قويّة للصّد منذ مُراهقتي، لم أرخ شعري على كتفي ولا مرة في شوارع إدلب، كان دائماً مشدوداً على رأسي كحبال مرساة تواجه العاصفة، مما تسبب بانحسار شعري وعرّض جبهتي.
تعززت قناعتي بأهمية هذه الدفاعات بعيش مخاطر الوجود في المساحات العامة، فأولى اللمسات التي عرفتها – وحتى أول حُضن كان تَحرّشاً، أتذكّر ذلك الحضن جيداً، كنت في الصف العاشر أقطع الشارع أمام المعهد لحضور درس اللغة العربية عندما باغتي مُراهق وانقض علي يحضنني بقوّة وأنا أقاوم جسده كسمكة خارج الماء. حضرت صديقاتي المشهد وعندما سألني الأستاذ في منتصف الدرس عن سبب اصفرار لوني والرجفة، أخبرنه بما حدث، فأصبح ينتظرنا بنفسه أمام الباب.
الأعضاء الذكورية التي رأيتها -العشرات منها- كانت لمتحرشين يلتحفون العتم في زوايا الشوارع أو يمارسون الاستمناء في المواصلات العامة، يُشعرني التذكر بذات الحرج والاشمئزاز والرغبة في الاختفاء.
كانوا واثقين بنفسهم لدرجة أن العديد منهم كان يناديني وصديقاتي لنكتشف عند النظر إليهم أنه مُتعرّون، كنت أركض وقلبي ينبض كطبل، لم أسمع ولا مرة أن مدينتي المُحافظة شهدت أية حادثة لضرب أو اعتداء او اعتقال لأي من هؤلاء.
قالت لي أمي وأنا في المُراهقة “لا أحد يحاسبك على المشاعر، هي الأفعال ما سُتحاسبين عليه”، ففهمت أن المشاعر إجراءات نظرية ثانوية يُمكن دفنها بالقلب لتجنّب مخاطر قيادتنا نحو أفعال نُحاسب عليها، وفي مجتمعنا يتراوح الحساب بين القتل بداعي “الشرف” او الخروج عن شور العائلة، إلى تشويه سمعة العائلة والتسبب بنبذها من المجتمع للجيل العاشر.
في مدرسة “بليغ حمدي” صادقت فتاة جميلة وشاطرة لكن أهلي لم يتحمسوا لفكرة زيارتي لمنزلها مع أنني كنت أزور أغلب رفيقاتي دون مشكلة، عرفت لاحقاً أن أم صديقتي المُدّرسة صاحبة الروح البهيّة، هي حفيدة امرأة أحبّت شخصاً حبّاً جمّاً ورفض زوجها تطليقها، فتركت المنزل وهربت معه لتمضي بقية أيام حياتها بصحبته. حُرمت الجدّة طبعاً من رؤية أولادها وتبرأت منها عائلتها وعاش “عار” حبّها حتى وصل لصديقتي.
ما أخطر الحب!
في أحد مشاهد ذاكرتي الحيّة أجلس على الأرض ببيت جدي في “شارع الخمّارة” وأسمع جملة مُندهشة في حديث نسائي كنت أنصت له بإمعان، “بتحب جوزها اتخيلي!”، فتسأل أخرى باستغراب “كيف يعني؟”، وتعّلق أكثرهن رومانسية “اديش نيالها، تفيق كل يوم جنب حدا بتحبه؟”
وُلدت من زواج طفلة زُوّجت إقناعاً برجل لم تحبه بحياتها ولم تعرف غيره، كذلك أغلب النساء في عائلتي، إلى أن كسر جيلنا ذلك، لكن هل فعلاً عرفنا معنى أن نحب؟
قيل لي “بحبك” لأول مرة في حياتي وأنا في الخامسة عشرة من عمري، كان ذلك في اتصال على الهاتف الأرضي مع ابن الجيران، أغلقت الهاتف في وجهه مع أنني كنت أبادله الإعجاب، كيف لا أفعل ولديه ملامح كاظم الساهر؟
لم أسمع هذه الكلمة من أي صديق أو فرد من العائلة قبل هذا أبداً، وكانت أسرتي تسخر عادة -ومازالت- من العواطف “المشلّخة” والرومانسية وكلما ما يتعلق بالحب، ربما كآلية دفاعية للصمود في بيئتنا المُحافظة القاسية التي تُراقب أنفاس النساء. فكان أفراد عائلتي يكتفون بإظهار الحب بالأفعال، كتقديم المكدوسة التي تحتوي على أكبر عدد من حبّات الجوز، أما عبارات الحب والعواطف فتؤدي بالضرورة لأن تُتهمي بأنك “تمثّلين أفلام” وتتسبّب بـ”قلبان المعدة” في إشارة للقرف.
في مشهد آخر، في الجامعة أخبرني صديقي أنه بعلاقة مع امرأة لديها طفلة، وبُهتت، فسألته بكل سذاجة “كيف أحبّتك ولديها طفلة؟”، ولم يفهم سؤالي رغم تكراري له.
وهل يتسّع قلب الأم غير حبّ أولادها وأهلها؟
كسر القلوب..كأثار جانبية لدفاعاتي
دفعني فضولي لسماع وحضور مئات القصص عن أثمان خطيرة دفعها النساء التي سقطن في جرف الحب العميق رغم كل إشارات التحذير التي تحيط به والأسوار العالية التي تبينيها عائلاتنا ومجتمعنا والدين والتقاليد حوله، وصمّمت -دون إدارك- على الطيران فوقه بخفّة.
حاولت القبيسسيات في فترة مُراهقتي هدايتي للانضمام لصفوفهن، وكانت في إدلب مجموعة صغيرة منهن، جلست بين عشرات الفتيات في الحلقة بينما كانت الآنسة تتحدّث عن حب الله برومانسية هزّت قلبي، وعندما بدأت الفتيات بالعزف على الدفّ والغناء عن العشق والشوق والبكاء، عشت لحظة روحانية نادرة سمحت فيها للحب بلمس قلبي لأنه “حلال” ومسموح وتحت وصاية الآنسة ورعايتها.
قررت بعدها بعدّة سنوات أن أسافر لدمشق لدراسة الصحافة وفي كل من هاتين الجملتين “فضيحة” لأهلي، فالإدلبيات تدرسن فروعاً “بنّاتية” في حلب تحت رقابة الأهل وسلطتهم إلى أن يأتي نصيبها. وبهذا أصبحت تحت ضغط أكبر لأكون “محترمة ومؤدبة” وأثبت أنني “بنت ناس” رغم سفري ودراستي لهذا الفرع “المُنفلت” وألا أسلّم أي كان أي “مُستمسك” علي، وهل تأتي المُتمسكات ضد البنت بغير صورة الحب؟
عزّزت دفاعتي أكثر، وارتديت قناع الصلابة الضيّق لوقت طويل جداً حتى أصبح امتدادي، ونسيت كيف يبدو وجهي دونه.
أصبحت بارعة في فرض المسافات وإغلاق أية طرق قد تؤدي لقلبي، “جلمودة”، “قاسية”، و”مخيفة” وصفني الأصدقاء، فاستعدادي لقطع أية علاقة بأي مرحلة كان عالياً، في يوم أحذفك من حياتي وتختفي كأنك لم تكن، بهذه البساطة والقسوة.
صديقتي ديمة هي الوحيدة التي قالت لي قبل عدّة سنوات بأنني “عاطفية” وبأن ما أقوله عن نفسي هو أسوار بنيتها لأحمي نفسي من هذا، فالعواطف ضعف وأنا ألا أستطيع تحمل أعباء ذلك، سخرت منها كما نفعل في العائلة وضحكت، ثم رجف قلبي قاذفا دموعاً لم تتوقف تلك الليلة.
لم أدرك مدى تطوّر تقنياتي المُذهلة هذه إلا مؤخراً، عندما اكتشفت أقواها: وهو العمى الاختياري عن رؤية المُحبّين، حتى أولئك الذين يُجاهرون بالتقرّب مني.
أدركت الشهر الماضي مثلا عندما عدت لصوري القديمة، بأن أحد الأصدقاء المُقرّبين لي في دمشق كان يعشقني لسنوات بشكل بدى واضحاً من مجرد رؤية صورنا معاً، كان يحيطني في كل الصور، نظراته والحب طافح بشكل لا يدعو للشك، لكني لم أكن أرى ذلك وهو أمامي، بالأحرى تصدّيت لهذه الحب الطافح بإسدال ستار مُعتم يُناقض ملاحظتي الدقيقة و ذكائي العاطفي وهما أدواتي الأساسية في عملي الصحفي!
يوم التخرج من جامعة دمشق طلب صديق آخر أن نتحدث وحدناً قبل أن نغادر، كان هذا الصديق من المجموعة الصغيرة التي أمضيت معها كل أيام الدوام، وكنا نجلس على درج قسم الصحافة ونتكلم يومياً ونخرج معاً.
أخبرني على عجل بأنه أحبّني منذ عامنا الأول، تجمّدت دهشة وصمت إلى أن أنهى حديثه بأنه لا ينتظر جواباً وأنه أرادني أن أعرف فقط، أجبته بأنني آسفة لم أعرف، وكان ذلك اليوم الأخير الذي نلتقي به.
عندما أخبرت بقية أفراد المجموعة لاحقاً علمت أن الجميع يعرف ما عداي، حدث هذا مُجدداً مع رفيق مُقرّب كنا نلتقي يومياً أيضاً ونعمل معاً، عندما اعتُقل قبل الثورة بسبب نشاطه السياسي أخبرني أنه لم يحلم إلا بي وهو في مُنفردته، لكني حجبت المعلومة ومعانيها واسقاطاتها كما العادة، وضربتني الدهشة مُجددا عندما أخبرني صديق مُشترك بعد أعوام عديدة أنني كنت حبّ حياته لذاك الشخص كما اعترف له.
مرّت عدّة قصص أخرى عرفت فيها بعد سنوات وبالصدفة أنني كنت لطخة عمياء في علاقة حب من طرف واحد لأشخاص أقدرّهم، ولم يمتلكوا شجاعة زميل الجامعة لإخباري بالحقيقة.
و كنت أبرر عدم اعترافهم هذا بأنني “مخيفة”، وقويّة، والعديد من الرجال في منطقتنا لا يتجرؤون علي التعامل مع القويات المُستقّلات اللواتي يتحدّثن بصوت عال.
سقوط النظام.. والسقوط الحر في دوامّة المشاعر
وصلت في السنوات العشر الأخيرة لمرحلة هجرتني فيها كل المشاعر -ماعدا الخوف- لا حزن، لا فرح، لا حب ولا كراهية، مجرد فراغ أسود يستشري في القلب.
عندما أصيب شريكي السابق أثناء حصار حلب، كنت أتحدّث في فعالية بجامعة كولومبيا بنيويورك، فتحت الرسائل لأجد صورته مع رسالة من صديق يخبرني بأنه بخير، وضعت “إعجاب” وأكلمت الجلسة والتفاعل مع الطلاب الذين وصفوني بآخرها بأني “أمتلك حسّاً فكاهياً عالياً”.
وعندما اغتيل صديقي رائد الفارس انهالت رسائل الأصدقاء على هاتفي لتتأكد أني بخير، علمت منهم بالخبر، فتحت الفييس بوك لأجد صورته جثة هامدة مع قطن أبيض في فمه.
أغلقت موبايلي وضعته جانباً وأكملت شرب الشاي، نظر إلي صديقي المُقابل وخانته الكلمات، فجلسنا صامتين إلى أن حان موعد المغادرة.
فجر سقوط نظام بشار الأسد انهارت فجأة صمّامات الأمان التي ربطتها على قلبي لسنوات، وتهاوت عروش دفاعاتي التي بنيتها ورعيتها منذ الطفولة وأضفت لها صروحاً من الُدشّم بعد سقوط حلب عام 2016.
مفخخة انفجرّت بسدّ المشاعر لتطوف على يباسي في ذلك اليوم. فقدت السيطرة.. واستلمت للانجراف، كطفلة صغيرة في الأربعين أخذت أتلّمس مجهول المشاعر وأتعرف عليها لأول مرة: الحب دافء، الشوق يحرق، القهر بارد، والخذلان يوجع المعدة.
عدت لدمشق، وعلى عكس العائدين/ات الآخرين، لم يُدهشني الدمار والتعب ولا مظهر المجاهدين في الشوارع، فقد عشت بينهم ومعه لسنوات. أدهشتني النساء الواثقة تمشي في الشارع إلى جوارهم، والمطاعم والبارات والتجمّعات المدنية المختلطة ورؤية أشخاص من طوائف مختلفة تجلس معاً داخل البلد، هذا ما نسيته لسنوات خلال معيشتي في الشمال أثناء الحرب.
كانت الزيارة الأولى كافية لأسقط في جرف الحب دون معدّات حماية، ودون خطة ب حتى، وإذا كان لعام 2025 عنوان في حياتي، فهو عام المشاعر الجيّاشة الخارجة عن السيطرة، وأنا لا أفقد السيطرة أبداً، فماذا أفعل؟
تقول الناشطة الأمريكية نينا سيمون “الحرية هي أن تعيش بلا خوف”، ويغني محمد منير “وده حب إيه ده اللي من غير أي حرية؟” وأنا أعيش مع الخوف بلا حب ولا حرية منذ أربعة عقود.
لكن فيض المشاعر جعلني أستعيد الماضي بعيون جديدة، أكتشفت مثلاً أنني محظوظة بمرور حب لم تعرفه أغلب صديقاتي، شخص كريم جعل من سعادتي أولى أولوياته، عاش لي ودافع عني بحياته -بكل ما تعنيه هذه الجملة من معنى- ورغم أنه باع عشرتي لاحقاً مقابل قطعة خراء يابسة، إلا أن هذا لا يغيّر من فرادة التجربة.
أدركت أيضاً أن ما قالته صديقتي ديمة حقيقي، أنا عاطفية، وهل ينفع أن اعتذر من نفسي وأقول لها “أنا فهمتك” بعد كل هذه العقود من القمع؟ أنا فعلاً آسفة.
نشرب قهوة؟
في عام سقوط النظام خسرت أربعة أشخاص حسبت أنهم سيبقون معي مدى الحياة، ولم أتمكّن من دفنهن في أوراقي كما أفعل عادة، بسبب غرقي في دوامة المشاعر، فبقوا معلّقين حتى الآن، فما لا أكتبه لا يحدث بالنسبة لي.
وفي الساعات الأولى من هذا العام كُسر قلبي بخسارة جديدة قبل أن يتوازن أمام السيل، لكن بعض الراحلين لا يستحقّون شواهدا لقبورهم في مدوّنتي، يكفيهم حفرة نائية في زاوية الذاكرة تنمو فوقها صبّارة مُزهرة.
وبدلاً من أن تكون هذه المدوّنة قبراً آخراً لخيبة جديدة، سأدفن فيها خوفي من المشاعر، وأزرع مقبرتي الجماعية التي ارتكبتها زينة القويّة زعتراً أخضر وزيتون أجلس فيها مع كرسي إضافي وفنجان قهوة ثان، بانتظار من يُشاركني “الصبحية”.
هذه المادة منشورة في درج بتاريخ 13 فبراير 2026